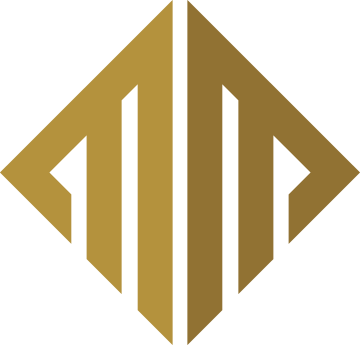أفصحت دراسات اقتصادية جديدة عن أن إقليم الشرق الأوسط، الذي يضم البلدان العربية، هو أكثر الأقاليم من ناحية عدم العدالة في توزيع الدخل على مستوى العالم. ففي هذا الإقليم يستحوذ أغنى 10% من سكانه على 64% من الدخل، مقارنةً بالأحوال في أوروبا التي يصل نصيب الشريحة نفسها فيها إلى 37%، وفي الولايات المتحدة نصل النسبة إلى 47%، وفي البرازيل 55%، وجنوب أفريقيا 62%. وتُظهر هذه التقديرات، التي قام بها الاقتصاديون فاكوندو ألفاريدو وليديا أسود وتوماس بيكيتي، أن تركز الدخول في الشرائح العليا يأتي على حساب الطبقة الوسطى فيضيّق عليها مصادر العيش، كما يدفع بالشرائح الأدنى دخلاً إلى مصائد الفقر.
وتختلف جذور اللامساواة بين مجموعات الدول المذكورة، ففي حين ترجع أسباب عدم العدالة في جنوب أفريقيا إلى نظام الفصل العنصري البغيض الذي ساد البلاد حتى أوائل التسعينات من القرن الماضي الذي منح 10% من البيض مزايا جعلتهم في قمة هرم الدخل، فإن عدم العدالة مرجعها في البرازيل إلى عهود طويلة من قهر ما يقترب من ثلث عدد السكان بنظم العبودية، التي استمرت فيها حتى صدرت قوانين منع الرق في عام 1887، بينما تمتد جذور عدم العدالة في توزيع الدخول في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط إلى الاعتماد على المصادر الريعية ثم تحويلها إلى أصول مالية وعقارية. وفي جميع الأحوال يرسخ قصور السياسات المالية العامة والإجراءات الضريبية حالات عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.
تتزايد احتمالات حالات عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة مع تضافر عوامل مختلفة مثل النشأة والموقع الجغرافي والنوع الاجتماعي والعرق، والتي قد تقلل من فرص الارتقاء وتحسن الدخل من خلال العمل. وقد أورد جارد دياموند في كتابه الأخير تحت عنوان «اضطراب»، أن الحراك الاقتصادي الاجتماعي في بعض الدول مثل الولايات المتحدة محدود، فأكثر من 40% من الذين يولدون لوالدين من الفقراء يظلون فقراء أيضاً في جيلهم عندما يكبرون عمراً، وأن 8% منهم فقط قد يصلون إلى الشرائح الأغنى دخلاً، أما في الدول الاسكندنافية فإن فرص استمرار البقاء في دائرة الفقر لأبناء الفقراء أقل، إذ تبلغ 26% فقط بينما يرتقي أغلبهم في سلم التطور الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما تتيحه لهم فرص التعلم والعمل وغيرها من ممكنات التحسن.
وهناك ظاهرتان متزامنتان شهدتهما العقود الثلاثة الأخيرة، الأولى تتمثل في انخفاض اللامساواة في الدخل بين الدول منذ عام 1990 بما عكس تراجع نسبة الفقر المدقع وكذلك ارتفاع معدلات نمو الاقتصادات النامية عن نظيراتها في الدول المتقدمة. أما الظاهرة الثانية فهي ارتفاع حدة عدم العدالة في توزيع الدخول داخل الدول على نحو غير مسبوق خلال الفترة نفسها. ولا يقتصر التباين على الدخول المتحصلة أو الثروات المكتسبة، ولكنه يمتد إلى خلل في مدى عدالة الفرص في الحصول على غذاء مناسب وخدمات الصحة والتعليم والأراضي وغيرها من أصول وموارد لازمة للعيش الكريم.
ولا ينبغي النظر إلى عدم العدالة في توزيع الدخول على أنها من الثوابت الجامدة العصية على التغيير، فلها من إجراءات السياسات وأعمال المؤسسات ما يحسن من أوضاعها ويعزز فرص عموم الناس في الارتقاء بأحوالهم من خلال العمل. ولتفادي موبقات عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة وآثارها السلبية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وما تفوّته على الاقتصاد من منافع، فعلى الحكومات أن تتبنى سياسات متكاملة للارتقاء بالعدالة في توزيع الدخول.
وفي هذا الصدد يجب ألا تقتصر هذه السياسات على توزيع المنح والهبات، بل عليها أن تعمل على خمسة محاور:
أولها يتعامل مع جذور اللامساواة من خلال قوانين وسياسات تطبَّق لإزالة العوائق كافة أمام الحصول على فرص عادلة بدايةً من الطفولة المبكرة بتغذية مناسبة وتعليم لائق ورعاية صحية متميزة، بما يضمن أن ما عاناه جيل الآباء من شظف العيش والفقر لا يرثه الأبناء.
ثانياً، ستحتاج هذه السياسات إلى تمويل يعتمد على نظام ضريبي كفء لتعبئة الموارد ويسهم في إعادة توزيع الدخول ويساند نظام الضمان الاجتماعي، وإلى نظام فعال للإنفاق العام يحسن استهداف المستحقين. ولعل منهج توطين التنمية يعين في فاعلية تحقيق استهداف المستحقين من خلال مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات وصياغة الأولويات وتنفيذها بما يحقق نفعاً ملموساً لعموم الناس.
ثالثاً، تطوير قواعد البيانات والارتقاء بنظم تحليلها لضمان فاعلية السياسات وعدم إهدار الموارد والعمل على كفاءة تخصيصها وتحديد المستحقين الأَولى بالرعاية والمساندة. وتحتاج سياسات الدخول وتحقيق العدالة في توزيعها إلى تطوير مسوح وبحوث ميزانية الأسرة التي تحتاج إلى تمويل لإجرائها بشكل دوري وتحليل بياناتها بالتكامل مع مصادر المعلومات الأخرى كالبيانات الإدارية والضريبية للحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن المجتمع الاقتصادي.
رابعاً، الاستعداد لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وقوامها أسس الاقتصاد الرقمي وتطور شبكات المعلومات وإتقان علوم الذكاء الاصطناعي، فالتهاون في الاستثمار في هذه المجالات من شأنه أن يُحدث فجوة في فرص التقدم بين الدول وتبايناً في مقومات المنافسة واكتساب الدخول بين الناس في الدولة الواحدة.
خامساً، تنفيذ استراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل للجميع باعتبارها السبيل لتحقيق فرص زيادة الدخول مقابل إنتاجية تحققها قطاعات الاقتصاد ومشروعاته، وأن المنافسة بين الاستثمارات المولِّدة لفرص العمل خصوصاً في مراكز تركُّز السكان من شأنها تحقيق التقارب في مستويات الدخول وفقاً لمعايير الإنتاجية والكفاءة. كما أنه ليس من سبيل للحاق الدول الأقل دخلاً بتلك الأعلى منها دخلاً من دون زيادة معدلات النمو الاقتصادي باطراد لا انقطاع في مساره.
وحتى تنجح المساعي المنشودة في إطار المحاور الخمسة المذكورة تنبغي مراجعة دور الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، فقد أُممِّت خطأً أنشطة كان الأَولى بها القطاع الخاص باعتبارات تكوينه ومنهاج عمله وسعيه للربح، وخُصخصت خطأً أنشطة كان الأَولى بها القطاع الحكومي باعتبارات فلسفة وجوده ومقاصد أنشطته المحققة للنفع العام. وهذا لا يقلل من شأن أعمال خدمية وأنشطة خيرية يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص والموسرون، والتي يجب أن تدعم وتحفز لمساندة تطور المجتمع والإسهام في الارتقاء بمجالات كالتعليم والرعاية الصحية ومكافحة الفقر ورعاية ذوي الحاجة من خلال نظم الوقف والتبرع والصدقات والزكاة. وقد كان في سابقات عهد الموسرين العرب، وفي بعض حاضرهم، مَن أسهم في تأسيس المدارس والمبرّات وراعى طلاب العلم وأنشأ الأوقاف للمقاصد الكريمة. وهي أنماط من السلوك والأعمال تبناها كثير من أغنياء الغرب فأنشأوا بها مؤسسات طوّرت التعليم ونظم الرعاية الصحية ومكافحة الفقر والجهل والمرض في بلدانهم وغيرها، وأسهمت في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.