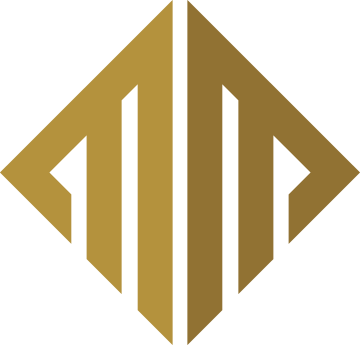تعرفت على الأستاذ علي إبراهيم صاحب القلم الرشيق والأدب الجم في أحد المؤتمرات الاقتصادية بلندن في عام 1990 أثناء دراستي بإنجلترا. وكان وقتها في بداية عمله بصحيفة «الشرق الأوسط» معنيًا بملفات الاقتصاد. وعلى مدار أكثر من ربع قرن لم يتوقف «الأستاذ علي» فيها عن ثلاث دعوات يوجهها إلي كلما رأيته أو تحدثنا هاتفيًا. أما الدعوة الأولى فكانت دائمّا إلى حوار عن المستجدات السياسية والاقتصادية، سواء كان ذلك بغرض النشر أو لخلفية عن موضوع يعده. كان نهمًا في الاطلاع على كل ما هو جديد لا يفوته خبر وهو معني بما وراء الخبر، فيسألك عما يتراءى لك من أسباب وما قد يترتب على الأمر من نتائج. وبحرفية بالغة يستخرج الإجابات بسهولة ويسر، وقد قام بواجبه إعدادًا وتحضيرًا وهو لا يفعل ذلك استعراضا لمعلومة أو مزايدة على من يحاوره بل لينفذ لصلب الموضوع باحثًا على الدوام عن السبب والنتيجة وتداعيات الأمر وسبل علاجه. ما زلت أذكر أحد حواراته معي بعد أن شاركت في مؤتمر عن الاقتصاد والاستثمار في لندن منذ عدة سنوات والتقيت عددًا من الوزراء والمستثمرين، استقبلني بشوشًا كعادته قائلاً: لن أسألك عن المؤتمر أو لقاءاتك، فسنقرأها منشورة غدًا في صحف عدة، لكني مهتم بما أشرت إليه سريعًا عن مشروعك لتأسيس بورصة جديدة في مصر للشركات المتوسطة والصغيرة. وكان قد جمع ما تيسر له من خبرات الدول مع هذه البورصات المتخصصة وانبرى يسأل عن الهدف من المشروع والفروق بين هذا النوع من البورصات والبورصات العادية ومؤشراتها والتوقعات لحجم نموها وكم سيستغرق من الوقت وتأثير أزمة الرهونات العقارية الأميركية عليها. بعدما انتهى من أسئلته، ضاحكته قائلاً: حسبتك قد ودعت الاقتصاد وشغلتك الشؤون السياسية، فرد سريعًا وهل ينفصلان؟ وعامة يا سيدي كما نقول في بلدنا «يموت الزمار وأصابعه تلعب»! واستمر العازف الماهر بالحروف والكلمات يمتع ويفيد القارئ بحوارات ومقالات لا يفصل فيها بين السياسة والاقتصاد حتى مات. أما الدعوة الثانية لـ«الأستاذ علي» فكانت مرتبطة بكرمه الحاتمي الذي كثيرًا ما نوه عنه أصدقاؤه وزملاء مهنته. فهو لا يفوت فرصة ليدعوك لتناول طعام غداء أو عشاء في أحد المطاعم اللندنية العتيقة البسيطة التي لا يرتادها السياح أو القاطنون المحدثون. وفي زيارات لي من واشنطن إلى لندن لم تكن لتكتمل إلا بلقاء معه في أحد هذه المطاعم داعيًا لعدة أصدقاء ويمتد الحديث لساعات متأخرة لا ينهيها إلا صوت مهذب مؤذنًا بموعد الإغلاق. وكأنه كان يجد في حرصه على دعوات الأصدقاء بعض تعويض عن حياة افتقدها في الغرب من حميمية وكرم ودفء للعلاقات بين الناس، وإن تناقشنا يومًا أن هذه من أمور طيبة لزمان ولّى بناسه وليس لتغير المكان بها علة، فكان يضحك معلقًا بالتعبير الدارج في الخليج «راحوا الطيبين». أما الدعوة الثالثة له فكانت للكتابة بصحيفته. وهي دعوة استطعت تلبيتها أحيانًا. وكانت أول تلبية للدعوة في بداية التسعينات عندما أصر أن أكتب عرضًا لمناقشات الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط في إحدى مراحل نشاطها وكان الموضوع عن السيناريوهات البديلة للتعامل مع مصادر المياه بين المشاركة والتقسيم، وهو موضوع استمر منشغلاً به وتناوله في مقالاته الأخيرة. وقد ظل حريصًا في تجديد الدعوة للكتابة كلما رأى أن كتابة المقال فيها أجدى من حوار في موضوع معين. وقد تكررت الاستجابة مني كتابة في موضوعات الاقتصاد العالمي وصعود الدور الآسيوي والأزمة المالية العالمية وغيرها. في إحدى زياراتي له بالمستشفى العام الماضي، بحضور السيدة الفاضلة قرينته وإحدى كريماته، تحدثنا عن دوافع الكتابة وكان مشتاقًا للعودة إلى مقالاته وتذاكرنا فيما قاله الكاتب الشهير جورج أورويل في مقالته بعنوان «لماذا أكتب؟»؛ إذ تناول أربعة أسباب للكتابة من إظهار للرأي، ونقل للحقائق ورصدها للأجيال القادمة، ولإحداث التغيير، ولما يجده الكاتب في الكتابة من سعادة. وأشار «الأستاذ علي» صراحة إلى ما لم يذكره أورويل إلا ضمنًا، وهو أن في الكتابة علاجًا له بعد الأزمة القلبية التي أصابته وكان يشبهها بـ«صدمة القطار». وهو ما حرص على أن يفعله حتى قبل عودته إلى بيته فكتب مقالته التي أعادت «الشرق الأوسط» نشرها مؤخرًا بعنوان «تحويشة العمر» وهي عن وفاء أصدقائه في بلده مصر وفي الخليج وبريطانيا وغيرها من أماكن وهو ما اعتبره رصيده المتراكم عبر الأيام. ودعنا «الأستاذ علي» وذهبت دعواته معه وبقيت من بعده سيرة عطرة بالجهد والاجتهاد وحوارات ممتعة وكلمات ذكية ومقالات تنير الطريق لمن أراد. ودعنا ولم ينفق من «تحويشة العمر» شيئا، فهي في زيادة تنميها أسرته الكريمة وأصدقاؤه وزملاؤه الأوفياء.